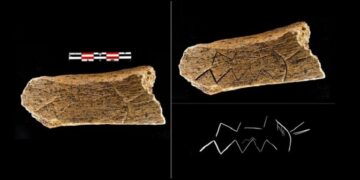في كل صباح، كان يجلس قبالة النافذة، ليتأكد أن الزمن ما زال يتحرك خارجه. فداخله كل شيء متجمّد.
تلك اللحظة بين الشهيق والزفير، حيث لا حركة ولا قرار، امتدّت فيه شهورا.
لا فرح، لا حزن… فقط بلادة شفافة تبتلع كل شيء.
حياته تشبه كوبا ممتلئا حتى الحافة، لا يمكن إضافة شيء إليه، ولا شرب شيء منه. كل محاولة للتحرك تسكب شيئا من كرامته بصمت.
لم يكن عاجزا، لكنه لم يكن راغبا. والإرادة حين تغيب، تسكن حفرة عميقة، سوداء، ناعمة الحواف.
على الطاولة أمامه، تراكمت أوراق بيضاء، لا تشكو شيئا سوى الصمت والابتعاد عن الأقلام.
كل مشروع بدأه ظل ناقصا، كأن النهاية تخونه دائما، أو كأنه يخشى أن يرى ما كتب. يخشى أن يكتشف أنه عادي… مجردا من البريق الذي وعد به نفسه ذات مساء مراهق.
كان قد قرأ يوما أن الإبداع يولد من الشرخ، لكن شرخه اتسع حتى ابتلع الرغبة ذاتها.
في المرات النادرة التي خرج فيها من البيت، كان يشعر أن العالم يتحرك بغيره. الجميع يركض، ينجز، يضحك، يشكو من ازدحام الوقت.
أما هو، فيتمدد زمنه على أرضية الغرفة، ميت، لا يدفنه أحد .
تذكّر قولا سمعه مرة: “احذر أن تصبح مثقفا يراقب حياته من بعيد.”
ضحك يومها… لم يكن يعرف أن هذه الجملة ستتحول إلى لعنة.
لعنة جعلته مراقبا لفيلم ممل .. لا حبكة له ولا موسيقى ولا قرار.
في الليل، حين تشتد الوحدة وتخفت ضوضاء الخارج، يسمع ذلك الصوت الداخلي.
صوت لا يمارس الصراخ ولا المواساة .. صوت متمرس في الهمس فقط .. يهمس له:
“لو كنتَ كافيا، لكتبت.”
في بداية الهمس، بدا الصوت غريبا فقاومه.. ثم ألفه فناقشه.. وبعد عدة مناقشات صار من الممكن أن يتعايش معه، وفي النهاية بات يصدقه.
صوته الداخلي لا يريد إقناعه بشيء… فقط يحرس الاستسلام.
الذكريات تزوره بلا إستئذان..
لحظة أول جائزة نالها في المدرسة.
صوت المعلمة قائلةً: “أنت تملك شيئا مختلفا.”
كتب كثيرا بعدها، بإيمان بريء أنه سيكون عظيما يوما ما. ثم جاء الواقع، فهاجمه الخوف، وطرحه الإرهاق أرضاً .
أدرك متأخرا أن الأمل لا يموت فجأة، بل يمرض طويلا.
في إحدى الليالي، حلم بأنه يكتب على جدار غرفته جملة واحدة، بخط مرتجف:
“سامحني، لم أكن قويا كما ظننت.”
استيقظ مذعورا، لم يكن يعرف إن كان يخاطب نفسه… أم يخاطب الطفل الذي كانه.
في صباح اليوم التالي، حاول أن يبدأ من جديد. جلس، تنفّس، وكتب جملة واحدة:
“الإحباط هو كثافة زائدة لا تجد طريقها للخارج.”
قرأها مرات عدة، ثم مزّق الورقة. فتلك الجملة أقوى من أن يحملها الورق، وهو أضعف من أن يعترف بها ثانية.
أدرك فجأة أن الإحباط رفيق ثقيل، يتكلم بصوته، ويجلس في كرسيه، ويشرب قهوته…
والأصعب من محاربته، أن تُقنعه بالمغادرة.
في المساء، عاد إلى النافذة. لكن هذه المرة توقف عن مراقبة الزمن، وراقب صورته المنعكسة على الزجاج.
فرأى شيئا جديدا في عينيه كان أكثر صدقا… و كذلك أكثر تعبا.
وقبل أن يغلق الستارة، كتب على حافة الزجاج بأصبعه:
“أنا لست عاجزا، أنا تائه في داخلي.”
غفران جميل